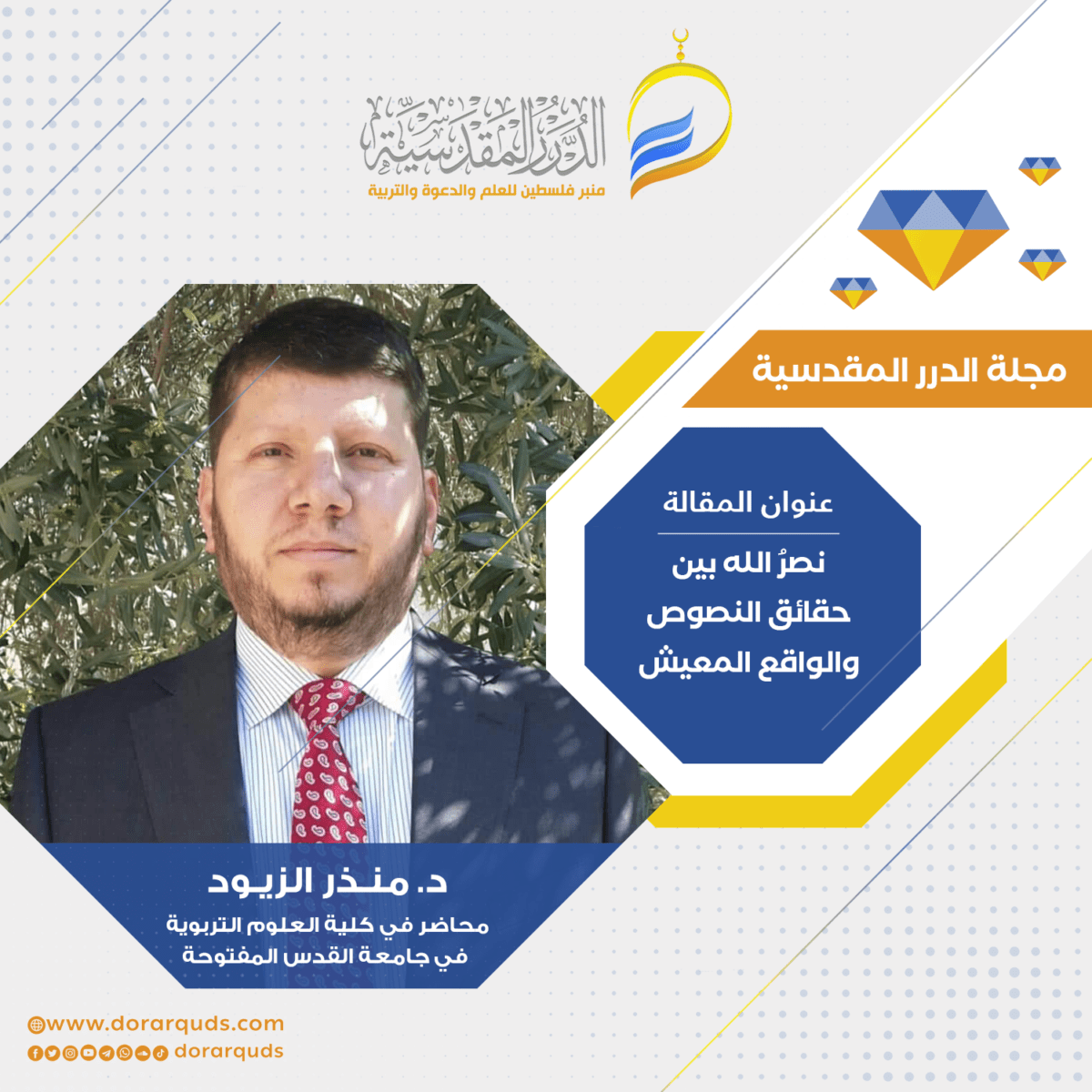
بسم الله الرحمن الرحيم
(نصرُ الله بين حقائق النصوص والواقع المعيش)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أرسل الله عز وجل رسله بالآيات البينات، والحجج الظاهرات؛ لدعوة الناس إلى عبادته وحده دون نِدٍّ أو شريك، وقد تكفّل لهم بنصرهم وإظهارهم على أعدائهم، مبيّنا لهم أن وعده بالنصر واقع ومتحقق لامحالة؛ إذ مضت سُنَّته، التي لا يعتريها خُلْف ولا تبديل، بنصر المؤمنين المخلصين، وإظهار صفّهم على أعدائهم عند النزال، وملاحم القتال، وهوما أشار إليه، سبحانه وتعالى، حينما خاطب المؤمنين عقب صلح الحديبية بقوله: (ولو قاتلكم الذين كفروا لوَلَّوا الأدبار ثم لا يجدون وليّا ولا نصيرا * سنّة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنّة الله تبديلا). [الفتح:22-23]
وثمَّ آيات كثيرة في كتاب الله، عزَّ وجلّ، توضح هذه السنّة الربانية الماضية بنصر الرسل وأتباعهم، وإظهارهم على أعدائهم، منها قوله تعالى: (حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذبوا جاءهم نصرنا فنجِّي من نشاء ولا يُرَدُّ بأسنا عن القوم المجرمين)[يوسف: 110]، إذ حملت هذه الآية في ثِنْيِها إخبارًا عن تلك السنّة الثابتة، وذلك الوعد الذي لا يُخلَف، مبيّنة أن النصر إنما يأتيهم حين اشتداد الأزمات بهم، واستحكام حلقات الكروب فيهم، واستفراغهم كل جهد في سبيل إيمان أقوامهم، وتصديقهم بدعوتهم التي أُرسلوا بها، حتى إذا استيأس الرسل من إيمان أقـوامـهـم وتصـديقهم، وظنت تلك الأقوام- لتأخر تحقق الوعد بالنصر- أن رسلهم قد كذَبوهم؛ أتاهم النصر، فنجِّي الرسل وأتباعهم من المؤمنين، وحلَّ العقاب والعذاب بالكافرين المكذبين.
جاء في الظلال: (في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب، ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل، ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة … في هذه اللحظة، يجيء النصر كاملاً حاسماً فاصلاً؛ (جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين)، تلك سنّة الله في الدعوات، لا بد من الشدائد، ولا بد من الكروب، حتى لا تبقى بقية من جهد، ولا بقية من طاقة، ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة، التي يتعلق بها الناس).
ومما يعضد هذا المعنى، ويؤكد ثبات تلك السنّة ودوامها، قوله تعالى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب). [البقرة: 214]
ولئن كانت هذه الآية – من حيث نزولها – قد نزلت يوم الأحزاب، غير أنها ليست مباينة لسابقتها؛ إذ جاءت لتكشف عن سنّة الله عزَّ وجل في نصر رسله وأتباعهم من المؤمنين، مبيّنة أن النصر إنما يكون مسبوقا بساعات تتعاظم فيها الشدائد بالرسل وأتباعهم بما يلاقونه من أعدائهم من إيذاء وتكذيب، وتحريض وتأليب، حتى إذا وصلت فيهم الشدائد ذروتها وغايتها، وبلغت منهم الكروب مبلغها، ونفد ما بهم من الصبر؛ أتاهم النصر الذي وُعِدُوه بعد مُقاساتهم كلَّ تلك الكروب والخطوب.
ويتضح من الآية السابقة أن هذه الأمة، من حيث الابتلاءات والشدائد، ليست بدعـاً من الأمم؛ فحالها كحال الأمم السابقة الّتي أصابها البأساء والضراء، وإنما كان هذا الإخبار عن تلك الأمم؛ من أجل أن تَتَأَسّى هذه الأمة بهم إذا جرى لها مثل ما أصاب أسلافها، ليستبشروا عند ذلك بحصول النصر لهم لدى بلوغ الشدة منهم ذلك المبلغ.
جاء عن خباب بن الأرتّ، رضي الله عنه، أنه قال: شكونا إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا ؟!! ألا تدعو لنا ؟!! فقال عليه الصلاة والسلام: (قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل، فيُحفَرُ له في الأرض، فيُجعَلُ فيها، فيُجاء بالمنشار، فيوضع على رأسه، فيُجعل نصفين، ويُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله! ليُتِمَّنَّ الله هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون).
ولما لم يكن الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، وأمته بدعا من الرسل والأمم من حيث الشدائد، فلا ريب أنْ تكونَ عاقبة أمرهم كأسلافهم، من حيث النصر والظفر، إذ إن إرادة الله عز وجل وسُنَّته قد اقتضت ذلك، ومَضَت به كما أخبر الله عز وجل عن ذلك بقوله: (ولقد كُذِّبت رسل من قبلك فصبروا على ما كُذِّبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين) [الأنعام :34]، فقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بالكلمات في قوله تعالى: (ولا مبدل لكلمات الله) هو ما وعده الله عز وجل لرسوله، صلى الله عليه وسلم، من الظفر على أعدائه، والنصر على مخالفيه، وأن هذا الوعد حقٌّ وصِدْقٌ، يستحيل تطرّق الخلف إليه.
والتعبير بـ(كلمة الله) جيء به في غير آية من كتاب الله، إذ يقول سبحانه: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين* إنهم لهم المنصورون* وإن جندنا لهم الغالبون) [الصافات:171-173]، فكانت هذه الآية تحمل في طيَّاتها معنى سابقتها، وتفيده بما فيها من وعد الله سبحانه لعباده المرسلين وأتباعهم بنصرهم وإظهارهم على الكافرين، مبيّنة لهم أن هذا الوعد قد مضت به سنَّة الله تعالى التي لا يطرأ عليها الخلف ولا التبديل.
جاء في الظلال: (هذا الوعد سنة من سنن الله الكونية، سنّة ماضية، كما تمضي هذه النجوم في دوراتها المنتظمة … لقد سبقت كلمة الله، ومضت إرادته بوعده، وثبتت سنّته، لا تتخلف، ولا تحيد).
وليس هذا الوعد محصورا في نصرة الرسل وأتباعهم بالحجج في الدنيا، وبانتقام الله، عزَّ وجلَّ، من أعدائهم في الآخرة فحسب، وإنما يكون نـصـرهم وإظهارهم في الدنيا بإهلاك الأعداء، وقهرهم بالقتل، والأسر، والإجلاء، وبالحجة والبرهان، وفي الآخرة بالفوز بالجنان، والنجاة من النار، ومما جاء مؤكداً على تحقق هذا الوعد قوله تعالى: (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) [غافر :51]، فقد حملت هذه الآية معها بيانا لشأن الله الدائب المستمر، وتقريرا لحقيقة كبرى، وسنّة ثابتة في نصرة الرسل وأتباعهم، وإن طال بهم الزمان، واشتدت بهم المِحَن، وهي كقوله سبحانه: (ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقًّا علينا نصر المؤمنين) [الروم:47]، فقد أشارت هذه الآية إلى سنّة ثابتة، وحقيقة دائمة، مفادُها أن نصر الله تعالى لعباده المؤمنين حقٌّ عليه سبحانه أوجبه على نفسه تفضلاً منه وتكرماً، وأن تلك العدة متحققة لا محالة؛ لكونها من صادق الوعد، الذي لا يخلف الميعاد). (وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون) [الروم:6].
ويتضح من الآية أن الوعد بالنصر والتمكين ليس محصورا في الرسل، عليهم الصلاة والسلام، وإنما هو عامٌّ للمؤمنين جميعهم؛ فتشمل الرسل، ومن بعدهم من المؤمنين، ولا ريب في أن هذا الوعد أمر قد قضى الله، عز وجل بتحققه، وحَكَمَ بوقوعه منذ الأزل، فقد قال سبحانه: (كَتَبَ الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز) [المجادلة:21]
ويستبين صـدق تحقق هذا الوعد بجلاء من خلال الربط بينه، وبين الآيات المتحدثة عن سنن الله الكونية التي لا تتخلف، إذ يقول سبحانه: (ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بُغِيَ عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور* ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير). [الحج: 60-61]
جاء في الظلال: (بعد ذلك يربط السياق بين وعد الله بالنصر لمن يعاقب بمثل ما عوقب به ثم يقع عليه البغي … يربط بين هذا الوعد، وسنن الله الكونية الكبرى التي تشهد بقدرة الله على تحقيق وعده، كما تشهد بدقة السنن الكونية المضطردة، مما يوحي بأن ذلك النصر هو إحدى هذه السنن التي لا تتخلف) .
وفي مقابل تلك النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية التي جاءت تُبَشِّرُ بحتمِيَّة انتصار المؤمنين، وتؤكد انكشاف ما نزلَ بهم من البلاء المبين، إلا أنَّ نظرة فاحصة في أحوال الأمة الإسلامية اليوم يجدُها تعصف بأبنائها في شتى بقاع الأرض محنة مشتركة، تتمثَّلُ في استباحة أرض المسلمين وديارهم وأموالهم وأعراضهم، وسلب عزتهم وكرامتهم، وانتهاك حرماتهم، وتدنيس مقدساتهم، وجَعْلِهم شيعاً وأحزاباً؛ لتكريس الفرقة فيما بينهم، وإثارة الفتن والصراعات في أوساطهم، وإضعاف جـهـدهـم وقوتهم وطاقاتهم، وتضييق الخناق عليهم في حريتهم وحركتهم وعيشهم وقُوت يومهم، مما يعطل إرادتهم، ويسلبهم حرية تنفيذ الأحكام الشرعية التي تحفظ عليهم دينهم، وتنظم شؤون حياتهم، ويجعل منهم أسارى لمعونة أعدائهم؛ فيلتزمون أوامرهم، ويسيرون وفق إرادتهم ومناهجهم، مما يُظهِرُهم بين الأمم مَـهـيـضي الجناح؛ لا يقـوون على درء الأخطار المحدقة بهم، أو دفع مكائد المتربصين بهم من أعدائهم.
ولعلَّنا نلمح بوضوح أنَّ إذلال هذه الأمة، وامتهانها، وتضييق الخناق عليها في عيشها ما سعى إليه صانعوه؛ إلا ليبقى تفكيرها منحصرا في توفير مأكلها ومشربها؛ خشية أن يكون في رخائها وحريتها مدعاة للتصدي لأعداء الأمة الإسلامية الذين يَحْذَرون صحوة الإسلام، واشتعال جذوته في نفوس المسلمين، لئلا يكون حائلا بين أعداء الأمة الإسلامية وما يسعون إلى تحقيقه من رغباتهم باستضعاف الأمم، واستعبادها، وامتهان كرامتها، لذلك؛ فهم لا يَفْتُرون عن ديدنهم ذلك في المسلمين، حتى إذا قام من بين المسلمين من يريد إعادة المجد المسلوب، سعى أهل الكفر جميعا في التصدي له، والوقوف في وجـهـه، والعمل على تأديبه، لئلا يجترِئ غيره على تقليده في اعتراض هؤلاء المجرمين.
ومما يزيد في الألم، ويبعث على الأسى، ويجعل وقع الشدة أكثر إيلاما هو ركون المسلمين إلى اليأس، وقبولهم بما يلحق بهم من إيذاء وتعذيب؛ لظنهم أن تلك الشدائد قدر مقدور عليهم لا سبيل لهم إلى الخلاص منه؛ ولظنهم استحالة تحقُّق النصر لهم بسبب ضعفهم، وقلة استعدادهم، في مقابل استعداد أعدائهم، مما يسهم في بث الخَوَر في نفوسهم، وزيادة الضعف في صفوفهم دون العمل الجاد على محاولة رفع الأزمات التي يلاقونها، أو السعي الحثيث للخلاص من الشدائد التي يواجـهـونـهـا، مما يلبـسـهـم لـبـوس المستيئسين من زوالها، ويظهرهم بمظهر القانطين من تلاشي الصعاب التي يعيشونها، أو استعادة العزَّة التي يرومونها، ولا شكَّ في أن سيطرة مثل هذه المشاعر والظنون على النفوس تَصُبُّ في مقتل الأمة، وتعـاظـم هـوانـهـا، والفتِّ في عضد المخلصين من أبنائها؛ لأن في سيطرتهـا اسـتـسـاغـة للذل والهوان، واستمراء للهزيمة، ورضى وقبولا بالمنجزات الآنيَّة الآتية على حساب الدين والمبادئ، واعتزالاً للدعوة، وإهمالاً للجهاد في سبيل الله، ورُكونا إلى اليأس والقنوط، واستدراجاً لشباب الأمة بزرع الخوف والضعف في نفوسهم لدى رؤيتهم دعاة الحق يطارَدون، ويؤسَرون، ويُقتَلون من أعدائهم، مما يؤدي إلى عدم التأهب للصعاب والمشاقّ، ثم الفتور عن السير في طريق الدعوة، والانقطاع عنه.
ولعل لقائل، تسلَّل الشكُّ إلى قلبه، أو سعى إلى إدخال الشكوك والظنون في قلوب أبناء المسلمين، أن يقول: إن ذلك النصر لم يتحقق لجميع الرسل والأنبياء، ثم إن الدائرة انقلبت في بعض المواطن على المؤمنين، مما يعني خلفا في ذلك الوعد.
والجواب: إن ذلك الوعد الحتمِيَّ يشملُ الرسل والأنبياء وأتباعهم من المؤمنين، وإنَّ النصـر مـتـحـقق لهم، إما في حياتهم، أو بعد مماتهم، كما حصل من تسليط الله تعالى على بني إسرائيل، عند قتلهم يحيى، عليه السلام، حتى انتصر له، ثم إن النصر له صور متعددة، وقد يبطِئ أحياناً، غير أن العاقبة تكون لهم، ولمن بعدهم، (ولا يلزم انهزامهم – أي المؤمنين – في بعض المشاهد، وما جرى عليهم من القتل، فإن الغلبة كانت لهم ولمن بعدهم في العاقبة، وكفى بمشـاهـد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين مُثُلاً يُحتذى بها، وعِبَراً يُعتَبَر بها … ولأن قاعدة أمرهم وأساسه، والغالب منه الظفر والنصرة – وإن وقع في تضاعيف ذلك شَوْب من الابتلاء والمحنة- والحكم للغالب).
وهنا تلزم الإشارة إلى أن هذا النصر الذي وعده الله تعالى عباده المؤمنين يستلزم تأدية تكاليف العقيدة، والقيام بالعبودية الكاملة المخلصة لله، عز وجل، والسعي في نصرة دين الله وشرعه وأوليائه، والجهاد في سبيله لإعلاء كلمته، ولهذا يؤكد الله، عز وجل، تلك القضية بقوله: (ولَيَنْصُرَنّ الله من ينصره إن الله لقوي عزيز* الذين إن مكّناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور). [الحج: 60-61]، فقد جاء هذا الوعد بصيغة القسم؛ ليؤكد للمؤمنين تأكيدا لا يشوبه ارتياب أنه ناصرهم، ورافعٌ لواءهم، ومعلٍ كلمتهم، إن هم نصروا دينه وشريعته وأولياءه، وجاهدوا في سبيله، كي تكون كلمة الله هي العليا.
ولعل حقيقة تعلق النصر بالإيمان، وارتباطه به، وملازمته له تغيب عن أذهان كثير من المسلمين اليوم ممَّن يستبطئون النصر، مُغفِلين قضية في غاية الأهمِّيَّة، وهي أنَّ الله، عزَّ وجلَّ، ما كان لِيَذَرَ المسلمين اليوم على ما هم عليه من الشدائد وتوالي الانتكاسات، لولا ضعف الإيمان الذي يعتريهم، وانحراف مفهومه وحقيقته في نفوسهم، ولا سيما في ظل ما يحدث في أوساط المجتمعات الإسلامية من انحراف عقدي، ولَوْثات فكرية، وانهيارات أخلاقِيَّة، ومجاهرة في ارتكاب المعاصي والمُحرَّمات، وانجرار خلف أولئك الذي يسعون جاهدين لهدم البناء الأسري، وضرب الأسرة المسلمة في بنيانها، وتلويثها بأفكار دخيلة مسمومة تحرفها عن مسارها الحقيقي في تربية الجيل المسلم الذي يسعى نحو النصر والتحرير.
وختاما، فمع ما سبق إيراده من النصوص القرآنيَّة القاطعة بحتميَّة انتصار المسلمين؛ فإنَّ مما يُسلِّي النفس من الهموم، ويُسرِّي عنها ما يعتريها من الأحزان تلك النصوص النبوية التي جاءت من وسط الشِّدَّة والمحنة تحُثُّ المؤمنين على الصبر، وتبشِّرهم بكشف هذا الواقع المؤلم، فقد روى ثوبان عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (إنَّ الله زوى ليَ الأرض؛ فرأيت مشارقها ومغاربها، وإنَّ أمتي سيبلُغ ملكها ما زُوِيَ لي منها)، ولعلَّنا نجد هذه الثقة بوعد الله ونصره من خلال حديث الصخرة يوم الخندق، فقد روى البراء بن عازب: (لما كان حين أَمَرَنا رسولُ اللهِ، صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، بحَفْرِ الخَنْدَقِ عَرَضَتْ لنا في بعضِ الخَنْدَقِ صخرةٌ لا نأخذُ فيها المَعَاوِلَ، فاشتَكَيْنا ذلك إلى النبيِّ، صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فجاء فأخذ المِعْوَلَ فقال: بسمِ اللهِ، فضرب ضربةً فكسر ثُلُثَها، وقال: اللهُ أكبرُ، أُعْطِيتُ مَفاتيحَ الشامِ، واللهِ إني لَأُبْصِرُ قصورَها الحُمْرَ الساعةَ، ثم ضرب الثانيةَ، فقطع الثلُثَ الآخَرَ؛ فقال: اللهُ أكبرُ، أُعْطِيتُ مفاتيحَ فارسٍ، واللهِ إني لَأُبْصِرُ قصرَ المدائنِ أبيضَ، ثم ضرب الثالثةَ، وقال: بسمِ اللهِ، فقطع بَقِيَّةَ الحَجَرِ فقال: اللهُ أكبرُ أُعْطِيتُ مَفاتيحَ اليَمَنِ، واللهِ إني لَأُبْصِرُ أبوابَ صنعاءَ من مكاني هذا الساعة)، فقد جاءت هذه البُشريات من وسط الكرب الذي كان يعيشه المسلمون بعد أن تحالفت قريش وقبائل العرب مع اليهود لأجل حرب المسلمين واستئصال شأفتهم، وقد أخذت منهم الشدة مبلغها، وتعاظمت ذروتها حتى عبَّر القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى: (إذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شديدا). [الأحزاب: 10-11]، فكان بعد ذلك الكرب الشديد اندحار الأحزاب حتى قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (الآن نغزوهم ولا يغزوننا). [صحيح البخاري].
فاستبشروا أيها المسلمون بنصر الله القادم، وأعدوا لهذا النصر عُدَّته من الإيمان والتقوى، والاستمساك بحبل الله المتين، واعلموا أنَّ الله مولاكم وناصركم: (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبِّت أقدامكم). [محمد:7]
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
تصنيفات : قضايا و مقالات
